ان كان محمود درويش لا ينتمي الى جيل الروّاد الذين أسسوا الحداثة الشعرية على اختلاف مدارسها, فهو استطاع خلال عقدين أن يصنع ريادته الخاصّة مؤسساً فضاء شعرياً يضمّ مراحله كافة, جاعلاً من شعرّيته سلطة تشبه سلطة الرواد أنفسهم. إلا أنّ محمود درويش سرعان ما تمرّد على سلطته وعلى شعريّته و"بيانه" الشعري الذي ندّت عنه قصائده نفسها, منتقلاً من مرتبة التكريس الى موقع التجريب والبحث المستمرّ عن شعريّة أخرى ذات قطبين: الأول يقوم على أرض الماضي الذي هو الحاضر بصفته ماضياً, والثاني ينتمي الى دائرة التجربة الجديدة التي ترفض الثبات واليقين.
وقد تكون دواوينه الأخيرة خير دليل على معنى الاختبار الشعري الذي يخوضه نظراً الى خروجها من أسطورة الأرض والجماعة والوطن والالتزام والقضية وسائر المقولات التي طغت على مرحلة درويش الأولى, الى أفق ميثولوجي تنصهر فيه هذه المقولات انصهاراً ذاتياً وحلمياً. هكذا انتقل درويش من شعر القضية الى قضية الشعر ومن حماسة المقاومة الى سحر التمرّد, ومن وهج السياسة الى غموض "السياسي" وهلمّ جرّاً. والشاعر الذي كانت تسبقه قصيدته الى جمهورها أو جماهيرها بالأحرى, بات في الأمام وأضحت الذات الفردية بوتقة الذات الجماعية, والصوت الهامشي العميق بئر الصوت العالي, وأصبح الشعر فعل مقاومة في ما تعني من مواجهة للواقع وما وراءه, للعالم والميتافيزيق, للحاضر والحلم...
غير ان محمود درويش لم يقع في شرك الشعر النخبويّ ولو أن جمهوره العريض لم يعد قادراً على استيعاب شعريته الجديدة. فهو عرف كيف ينسج علاقته بالذاكرة المزدوجة: ذاكرته الشخصية وذاكرته الثقافية, موائماً بين اغراء الشعر الصرف الذي لا غاية له سوى نفسه, بحسب ما يقال عن قصيدة النثر الحديثة, ونداء الأرض بصفتها حنين الفرد والجماعة ومآل الذات والآخر(ين). وكلما أصدر محمود درويش ديواناً جديداً خطا خطوة واسعة نحو المستقبل الذي هو الحاضر في صيغة الغد. وقد يمثل ديوانه الجديد "لا تعتذر عمّا فعلت" (دار رياض الريس) ذروة نزعته الشعرية الجديدة المتجلّية في البحث الدؤوب عن إكسير الشعر, في اللغة كما في الحياة, في الذاكرة كما في الحلم.
قد لا يعجب قارئ محمود درويش (القارئ الحقيقي) من تسمية الشاعر الجزء الأول من ديوانه "في شهوة الايقاع", فالشاعر الذي لم يكتب أي قصيدة نثر خلال مساره الطويل يصرّ دوماً على اعتماد الايقاع التفعيلي. وقد أصاب في اختياره كلمة "ايقاع" عوض كلمة "وزن", فالايقاع, كما هو شائع, أشمل من "الوزن" وأوسع منه وأعمق, كونه يشمل موسيقى الحروف والكلمات والجمل, وقد اختبر درويش فعل الايقاع أيّما اختبار في هذا الديوان, سواء في تخلّيه عن التقفية في قصائد عدّة, أم في اعتماده التقفية الداخلية إن أمكن القول, وهذه لعبة غالباً ما يلجأ اليها درويش لإشاعة نوع من الموسيقى اللفظية في وسط الجملة الشعرية أو السطر الشعري, ما يجعل القصيدة تقترب من "التدوير" التفعيليّ, وما يضفي عليها الكثير من الانسيابية الطالعة من الإحساس الداخلي وليس من الصنعة فقط. والشواهد كثيرة ومنها مثلاً هذه المفردات التي ترد داخل الجمل: الاستعارة - الزيارة - انتظرت - اخترت - سهرت - طرت... وإن أصرّ الشاعر على مبدأ الايقاع التفعيليّ الحرّ, فهو أفاد كثيراً من قصيدة النثر, مناخاً وتقنية, علاوة على انفتاحه على ما يُسمى "نثر الحياة", وهذا ملمح مهمّ في شعره, فهو يحرّر قصيدته من "هلامية" اللغة التي نجدها بارزة لدى بعض الروّاد ومريديهم, ومن نزعة "المطلق" التي أنهكت القصيدة العربية مذ جعلتها تقترب من الحال النبوءاتية (اللفظية), ويحررّها من الواقعية الفجّة والالتزام المباشر والهمّ السياسي العام. وظف درويش المعايير التي استخلصتها الناقدة الفرنسية سوزان برنار في قصيدته محافظاً في الحين عينه على مبدأ الايقاع. ومن تلك المعايير التي استخدمها مثلاً: الإيجاز والكثافة واللمعة والحكاية... ولم يمل طبعاً الى "المجانية" التي فقدت أصلاً ذريعتها الشعرية حتى لدى شعراء قصيدة النثر, فالشاعر لا يستطيع أن يتخلّى عن علاقته بالمكان ولا بالتاريخ ولا بالذكريات...
"يختارني الايقاع, يشرق بي" يقول محمود درويش في مطلع أولى قصائد الديوان, معرباً عن علاقة داخلية بالايقاع الذي يستحيل لديه كاللهاث أو النَفَس المتصاعد من الروح. الايقاع قدر القصيدة وقدر الشاعر نفسه: ايقاع مفتوح على الحركة التي تنتظم الجسد والنفس, الحلم والواقع, الوهم والحقيقة. يصبح الشاعر "رجع الكمان" وليس "عازفه" كما يعبّر درويش, فالشعر هو الخفقان الداخلي الذي تخفيه الأشياء والعناصر, ووحده الشاعر قادر على سماعه وعلى دمج صوته فيه, صوته الصامت وايقاعه الخفي. وهو - أي الشاعر - "صدى الأشياء تنطق بي", وإذا أصغى الى الحجر "استمعت الى هديل يمامة بيضاء". لم تبق صفة الشاعر وقفاً على قدرته "الأورفية" في الهيمنة الغنائية على الأشياء والعناصر, بل أضحت الصفة تشمل قدرة الشاعر على انطاق تلك الأشياء والعناصر عبر الاصغاء الى كلامها الغائب والغامض والذي يدلّ على وحدة الكون أو الوجود. فهديل اليمامة يتصاعد من الحجر, لكنّ الشاعر هو القادر على الاستماع اليه. انه الايقاع قبل كلّ شيء أو "الموسيقى قبل أي شيء" كما قال بول فيرلين في مطلع قصيدته "فن شعري". وهذا الايقاع ليس مجرد تردادٍ موسيقي بل هو يولد, كما يعبّر درويش, "عند تشابك الصور الغريبة من لقاء/ الواقعي مع الخياليّ المشاكس", أي أنه الايقاع الكليّ الذي ينطلق من تقاطع الوعي واللاوعي, الحسّ والخيال, هذا التقاطع الذي تنبثق منه "الصور الغريبة". يختار الايقاع الشاعر, لتكون القصيدة رجع الكلام الأبديّ, الذي لا يقال. تصبح القصيدة مثيل ذلك "النحاس" الذي إذ استيقظ "بوقاً" فهذا ليس خطأه, بحسب عبارة رامبو الشهيرة.
بيان شعري
تتيح بعض قصائد درويش في الديوان استخلاص ما يشبه "البيان" الشعري الذي تنمّ به الجمل والصور والمجازات. فالشاعر الذي لم يسع يوماً الى وصف الشعر أو التنظير له والكتابة عنه شاء أن يحمل الشعر بنفسه نظريته, وأن يصهر تلك النظرية شعرياً, فلا تكون سابقة إياه ولا لاحقة به كما لدى الكثير من الشعراء. فالشعر هو الشعر, أي هو - كما يقول درويش على لسان ريتسوس - "الحدث الغامض" أو "الحنين الذي لا يفسّر, إذ يجعل الشيء طيفاً وإذ يجعل الطيف شيئاً". قد تحمل هذه الجمل القليلة الكثير من المعاني والدلالات, لكنّ الشاعر يتقن لغة "الاشارة" التي تختصر الكلام بجوهره والأشياء بما وراءها والزمن بلحظته الحيّة. الشعر أيضاً في نظر درويش هو "دمع الكلام" يذرفه الشاعر "باسم الذكرى". أما القصيدة - كل قصيدة - فهي "أم" و"حلم" و"رسم"... ويقول: "وجدت ما يكفي من الكلمات.../ كلّ قصيدة رسم/ سأرسم للسنونوة الآن خارطة الربيع/ وللمشاة على الرصيف الزيزفون/ وللنساء اللازورد". وإذ يقول انه وجد ما يكفي من "الكلمات" فهو يقول في قصيدة أخرى: "المفردات تسوسني وأسوسها. أنا شكلها. وهي التجلّي الحرّ/ لكن قبل ما سأقول". هنا يعود الشاعر الى جدلية الشعر والقصيدة أو الشعر والكلمات, علاوة على جدلية ماضي الكلمة وحاضرها. وإن لم يأخذ درويش - فرضاً - بمقولة الشاعر مالارميه التي تفيد بأن الشعر تصنعه الكلمات (في ما تعني الكلمات من ايقاع ومعنى) فهو يقول في احدى القصائد: "ضع الحروف مع الحروف لتولد الكلمات/ غامضة وواضحة/ ويبتدئ الكلام". ويعترف أيضاً بأن الكلمات تسوسه وهو يسوسها: انها علاقة خلق متبادلة وفيها يتعادل الطرفان, الشاعر وكلماته. انه شكلها فيما هي "التجلّي الحرّ". هكذا يكون الشاعر صنو كلمته وتكون الكلمة صنو شاعرها. أما أن يعترف الشاعر بأن ما يقوله الآن قيل سابقاً, فهذا نوع من التواضع الذي يخفي وراءه حالاً نرجسية في معناها الجميل. فالشاعر الذي حاول قتل "الأنا" المتعالية والمتضخمة عبر الاعتراف بأن ما يقوله ليس إلا رجعاً لما قيل سابقاً يستعين في إحدى قصائده بصدر بيت شهير للشاعر أبي العلاء المعرّي, ويبدّل فيه قليلاً, دافعاً القارئ نفسه الى تكملة البيت وفهم المغزى من العجز المحذوف. يقول درويش: "وأنا وان كنت الأخير...", أما البيت فيقول: "واني وان كنت الأخير زمانه/ لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل".
وفي قصيدة أخرى يسأل الشاعر نفسه: "هل كتبت قصيدة؟" ويجيب "كلا". أما السبب فهو "الملح الزائد أو الناقص" في المفردات. هذا السبب يزيد من شعرية الكتابة عبر تحرير الكلمات من جمودها المعجمي ومعناها الثابت أو العام. هل يمكن تصوّر مفردة ذات ملح قليل أو كثير إلا مجازياً أو شعرياً؟ يصبح للحروف هنا حاسّة ذوق مثلما أصبح لها لدى رامبو ألوان مختلفة. على أن درويش سيذكّر أيضاً برامبو إذ يمضي في وصف القصيدة قائلاً: "القصيدة/ زوجة الغد وابنة الماضي تخيّم في مكان غامضٍ بين الكتابة والكلام... فهل كتبت قصيدة؟ كلا!/ إذاً ماذا كتبت؟ كتبت درساً جامعياً/ واعتزلت الشعر منذ عرفت/ كيمياء القصيدة... واعتزلت". انها حال "رامبوية" بامتياز. فشاعر "فصل في الجحيم" كتب قصيدة "خيمياء الكلمة" واعتزل الشعر باكراً منذ أن عرف "كيمياء القصيدة". لكن درويش الذي يستعير قناع رامبو سيواصل الشعر حتى بعد أن وجد لغته.
لا يتبدّى "نثر الحياة" في الديوان فقط عبر المفردات اليومية التي يدرجها محمود درويش في متن القصائد وهي عادةً مفردات غير مألوفة شعرياً (الفيديو, المطبخ, العولمة, التكنولوجيا, السندويشات...) وانما أيضاً في انفتاح الشعري على اليومي والهامشي والعابر, وفي الاحتجاج واليأس, وفي الاعتراف الحميم والألم الشخصي... على أن يقابل هذه العناصر جميعاً احتدام ميتافيزيقي ولكن في منأى عن الدين تماماً. فالشاعر الذي يملك "حكمة المحكوم بالاعدام" يعترف جهاراً: "أقول: لست مواطناً أو لاجئاً/ وأريد شيئاً واحداً لا غير... موتاً بسيطاً هادئاً... في الطرف الخفيّ من الزنابق...". مثل هذا الموقف السلبي من الماضي وأعبائه لم يكن ليقال في الشعر التفعيلي الذي طالما ارتبط بالحماسة والنضال والثورة, لكنّ درويش يقوله في قصيدة توفق بين القالب التفعيلي والإضمار النثري. انه اللقاء المفاجئ دائماً الذي يشبه "التقاء الأخضر الأبدي/ بالكحليّ..." أو "التقاء الشكل بالمضمون والحسيّ بالصوفي..." كما يعبّر الشاعر. ولا عجب أن تعلو النبرة اليائسة بعض الشعر "الوطني" - إن كانت تصح الصفة - الذي يبرز حيناً تلو آخر في الديوان. إنه شعر "وطني" مكتوب بالرمق الأخير كما يقال, لكنه يعبّر خير تعبير عن الحال المأسوية التي بلغتها القضية الفلسطينية وقد أضحت قضية إنسانية بامتياز: "لبلادنا خارطة الغياب... لبلادنا وهي السبية حرية الموت اشتياقاً واحتراقاً..." يقول الشاعر. وفي قصيدة أخرى يصف مواطنيه - الذين هم نحن أيضاً - قائلاً: "لا ينظرون وراءهم ليودّعوا منفى! فإنّ أمامهم منفى, لقد ألغوا الطريق الدائري, فلا أمام ولا وراء/ ولا شمال ولا جنوب...". مثل هذه الأسطر الشعرية تختصر كلّ ما كتب ويكتب عن المأساة الفلسطينية التي أضحت مأساة بشرية عامة. ويتصاعد الغضب "الصامت" والخافت لـدى الشــاعر حـتى ليدعـو الى رفض كتابة التاريخ شعراً, فالتاريخ كان ولا يزال ضدّ الإنسان - الضحية وحليف الإنسان - الجلاد: "لا تكتب التاريخ شعراً... التاريخ يوميات أسلحة مدوّنة على أجسادنا... ليس للتاريخ عاطفة لنشعر بالحنين الى بدايتنا... كأننا منه وخارجه... انه فينا وخارجنا... وتكرار جنوني من المقلاع حتى الصاعق النووي...". هنا يفضح الشاعر التاريخ الذي كثيراً ما مجّده الشعراء, ويتبرأ منه كونه حكاية مكرّرة للقتل الذي كان المقلاع أداته الأولى.
[align=center]
يتبع[/align]
|
|
|




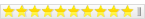


 محمود درويش يستعيد "نثر الحياة" ليجدّد القصيدة العربية
محمود درويش يستعيد "نثر الحياة" ليجدّد القصيدة العربية


 تواصل معنا
تواصل معنا إعلانات نصية
إعلانات نصية الخصوصية
الخصوصية



المفضلات