إلا أنّ النزعة النثرية تتجلّى في قصائد فريدة كتبها محمود درويش بمهارته التقنية المعهودة واستطاع ان يخلع عنها الطابع التفعيلي من غير أن يتخلّى عن التفاعيل. وهنا يكمن التحدّي الحقيقي: أن يكتب الشاعر قصيدة مزدوجة, قصيدة ذات شكل تفعيلي وجوهر نثري. ويكفي تسمية قصائد مثل: الظل (ص 83), لا شيء يعجبني (ص 85), هو هادئ وأنا كذلك (ص 87) وصف الغيوم (ص 89)... في هذه القصائد يختلط الشعري بالحكائي وتصبح اللحظة الشعرية لحظة سردية ووصفية ولكن انطلاقاً من نار الشعر الخفية. وهي لا تتخلّى لحظة عن غنائيتها المتوهجة. وفي قصيدة عنوانها: "ماذا سيبقى؟" لا ينتبه القارئ الى النظام التفعيلي, فالقصيدة تغريه إغراء نثرياً ويكاد النثر فيها يطغى على التفعيلة والقافية. وهذه ميزة تسم معظم القصائد في الديوان. أما قصائد الحب وهي قليلة, فلم تخل بدورها من الحنين النثري وهذا ما حرّرها من البعد الميثولوجي الذي طالما ربط في شعر درويش بين المرأة والأرض. في قصائد مثل "لا أعرف اسمك" و"هي في المساء" و"في الانتظار" يصفّى الحبّ من كلّ ما لا علاقة له به ويتخلّص من الترميز الذي أرهقه وتصبح القصيدة قصيدة حب صرف, حبّ واقعي مشحون بالأحاسيس والانفعالات الحقيقية. انها قصائد حب بديعة. تحضر فيها المرأة هاجساً يتأرجح بين الواقع والحلم, بين المشهدية والشعور المأسوي الدفين, بين التفاصيل الصغيرة والهموم الشخصية: "هي في المساء وحيدة/ وأنا وحيد مثلها.../ بيني وبين شموعها في المطعم الشتوي/ طاولتان فارغتان...".
جدلية الأنا والآخر
في مفتتح الديوان يثبت محمود درويش قولين شعريين, واحد لأبي تمام (لا أنت أنت/ ولا الديار ديار) وآخر للإسباني لوركا (والآن, لا أنا أنا/ ولا البيت بيتي). وقد يكون هذان القولان مدخلاً الى جدلية الأنا والآخر التي احتلّت الكثير من القصائد, على أن يكون الآخر في أحيان وجهاً في مرآة أو في صورة قديمة أو اسماً يخاطبه الشاعر أو ظلاً أو شبحاً. وان عبّر القولان الآنفان في ما يختزنان من معانٍ, عن صيرورة هراقليط التي تمثلت في ماء النهر المتبدّل أبداً, فإن محمود درويش ليس غريباً عن هذه الصيرورة التي ألمح اليها في حواره الذاتي مع "الأنا", الضمير المتكلم, الذي هو الآخر في وقت واحد. قد يكون من المفيد تذكّر مقولة رامبو الشهيرة (الأنا هو آخر) أو مقولة صموئيل بيكيت التي وردت في نصّه الجميل "اللامسمى" (أقول أنا, مدركاً أنه ليس أنا نفسي), لكن محمود درويش شاء الآخر صورة شخصية مشتتة عن الأنا - الجوهر, أو هو شاء هذا "الأنا" متعدّد الوجوه والتجلّيات, فإذا به يخاطب نفسه كما لو أنه يخاطب آخره الشخصي, كأن يقول: "لا تعتذر عمّا فعلت. أقول في سرّي. أقول لآخري الشخصي..." ويضيف: "همست لآخري: "أهو/ الذي قد كان أنت... أنا"... ويردف: "قلت لآخري لا تعتذر إلا لأمك". قد يظنّ القارئ للوهلة الأولى أن في مثل هذا الشعر ما يشبه الشرْك الذي يدفعه الشاعر نفسه اليه, لكنّ ورود كلمة "الأم" يؤكد أن هذه الثنائية (الجدلية) ليست إلا طريقاً الى الوحدة والى الانصهار الذاتي حيث تمثل الأم بصفتها رحم الولادة رمز العودة الى البداية التي ليست إلا النهاية (سألتقي بنهايتي وبدايتي, قال الشاعر في احدى القصائد). ولعلّ قصيدة "في بيت أمي" قد تكون دليلاً أيضاً على هذه "العودة" التي تلتحم فيها الثنائيات ولا سيّما من خلال ذوبان الشعري في الأبدي. وفي القصيدة يبدو الشاعر كأنه يقف أمام صورة له قديمة أي أمام "الأنا" الذي أصبح "آخر" على مرّ الزمن, "آخر" هائماً في متاهة الوجود, ولا يلبث الشاعر أن يسأل هذا "الأنا" قائلاً: "أأنت يا ضيفي أنا؟" ويجيب عنه: "قلت يا هذا, أنا هو أنت لكني قفزت عن الجدار... لكي أرى/ ما لا يرى/ وأقيس عمق الهاوية". هكذا يبدو الضمير المخاطب (أنت) الذي هو "الآخر" صورة "الأنا" في ماضٍ ما, وقد اكتسب ضمير "الأنا" صفة الشاعر الرائي بعدما قفز عن الجدار, جدار الزمن الذي يتجه الى ماضيه. وتستوقف الشاعر في هذا الحوار الذاتي مع صورته فكرة الأبدية التي هي الغاية التي ينشدها الشعر: "ما الأبديّ؟ قلت مخاطباً نفسي...", يقول الشاعر, وإذ يعترف بـ"هواية التحديق/ في الأبدي" التي علّمته إياها النجوم, لا يسعى الى تحديد الأبدية, على غرار ما فعل رامبو أو رينه شار مثلاً, علماً أنه يتحدث عن "الأبد الموقت في القصائد" والذي "لا يزول ولا يدوم". هذا وصف بديع للأبدية التي قال فيها رامبو: "ما الأبدية؟ انها البحر ممزوجاً بالشمس", والتي اعتبرها شار "ليست أبداً أطول من الحياة". الأبدية لدى محمود درويش هي اللحظة القائمة خارج الزمن, اللحظة لا تزول ولا تدوم.
يصبح الآخر في بعض القصائد "الوجه" الذي أخفته المرآة: "فالمرآة قد خذلتك/ أنت... ولست أنت, تقول: أين تركت وجهي؟". إنها الخيبة يخلقها الزمن الذي لا يرجع الى الوراء, خيبة فَقْدِ الوجه الذي قد يكون خير مرآة للزمن. هذه الخيبة عبّر عنها بورخيس ولكن في تداعٍ آخر, عندما نظر الى المرآة ولم يجد وجهه بل وجد انه فقد عينيه. يصبح "الآخر" أيضاً هو "الاسم" الذي يخاطبه الشاعر: "أما أنا فأقول لاسمي: دعك منّي... أعطني ما ضاع من حرّيتي", فالإسم قد يصبح بمثابة السجن الذي يأسر المرء ولا سيّما إذا كان شاعراً وشاعراً كبيراً وجماهيرياً. والتحرّر من الاسم هو تحرّر من الأرث الذي يصبح عبئاً كبيراً على صاحب الاسم. ويسمّي درويش الاسم "ظلاً". ويستحيل "الآخر" أيضاً شبحاً يصرخ بالشاعر قائلاً: "إن أردت الوصول الى نفسك الجامحة/ فلا تسلك الطرق الواضحة". انه الشبح "المقبل" الذي ليس المرء إلا "كثافته الحزينة" كما يعبّر مالارميه. أما الطريق الذي ينبغي له أن يكون "غامضاً" لأنه طريق الشعر, فيقول درويش عنه انّه "كلما طال تجدد المعنى" ويصير الشاعر, سالك الطريق, "إثنين", هو و"غيره".
مَن يقرأ ديوان محمود درويش يشعر بأنّه يحتاج الى أن يقرأه مرّة تلو أخرى, فهذا الديوان يمثل مرحلة مشرقة من مسار الشاعر ويحفل بنضارة نادرة هي نضارة الشباب. ويصعب تالياً الوقوف على ما يضمّ من جماليات ومعان وتقنيات شعرية فريدة وكثافات وصور وأنفاس غنائية... فالشعر هنا إصغاء ورؤيا وغوص في الأسرار واغراق في الحلمي (احلم تر الضوء في العتمة الوارفة, يقول الشاعر) وكتابة للحياة بصفتها قصيدة وعيش للشعر بصفته بديل العالم.
محمود درويش شاعراً شاباً؟ قد لا يثير هذا السؤال أي استغراب, حين يدرك قارئ الديوان أن سرّ هذا الشاعر يكمن في قدرته على البداية من النهاية, النهاية المؤجّلة دوماً والتي تتيح للشاعر أن يتجدّد, متجهاً عكس الزمن, من النضج الى النضارة, من التعب الى الحماسة, ومن السأم الى الألق. ولا عجب أن يكتب محمود درويش قصيدة جميلة جداً عن سليم بركات, الشاعر الفريد لغة ومناخاً أو أن يستشهد بجملة للشاعر بسام حجّار الذي يحل في موقع الصدارة مع شعراء ينتمون الى الجيل الجديد!
ترى, الى أي جيل ينتمي محمود درويش؟
منقول
|
|
|




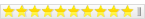





 تواصل معنا
تواصل معنا إعلانات نصية
إعلانات نصية الخصوصية
الخصوصية



المفضلات